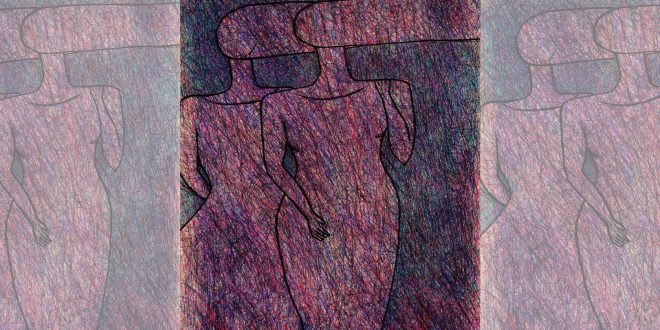شاركت عمليا في ثلاث مشاريع مهمّة أود الحديث عنها في بداية تدخلي لها علاقة بالموضوع من الجهة العملية وهي على التوالي:
– ورشة نصر سامي للأقصوصة: وهي مشروع ثقافي يتولّى تكوين الراغبين في الكتابة الأدبية القصصية، وأصدر هذا المشروع لحدّ الآن 27 كتابا ورقيا، وتم تنفيذه في سلطنة عمان، وفي تونس: صلالة (دورات متعاقبة)، منزل تميم (3 دورات)، السرس (1 دورة)، جبنيانة (3 دورات)، بنزرت (1 دورة)، قليبية (1 دورة)، مسقط (دورة واحدة).. وصدرت عن هذه الورشات كتب جماعية وفرديّة يفوق عددها 28 كتابا ورقيّا، ولقد لاحظنا حاجة المشهد الكبيرة إلى فهم الأجناس الأدبية وتعلم طرائقها واختيار الكتابة الأدبية طريقة في التعبير.
– السّوق الإبداعية: وهي فعالية استمرّت 9 دورات، تدور في الشارع، دون أيّ موافقات مسبقة، وهدفها الالتحام مع الشارع واقتراح منتج أدبي قصصي وشعري وفني مختلف. ولقد قوبلت هذه التظاهرة باهتمام كبير. والتحق بها كلّ المارين في الجوار. من الأماكن التي عقدت فيها: أمام محطة القطار بسوسة، الساحة الكبرى في باب بحر، سوق الحوت، إلخ.
– مبادرة 10 أفلام، 10 قصص، 10 ألعاب: وهي تظاهرة موجهة للتلاميذ في المدارس والمعاهد. ولاحظنا حاجة التلاميذ الواضحة إلى أنشطة فنية، ومطالبتهم بوجودها.
يؤدّي بنا هذا إلى ملاحظة مفارقة كبيرة مفادها أن الساحة الثقافية شجاعة في مقاربتها للموضوع، وواعية بحاجتها المتأكّدة إلى الفنون والآداب، وخصوصا ما كان منها كفيلا بحلّ مشاكلها مع الذات والعالم، وتأخّر المؤسّسة السياسيّة والثقافية والتعليمية عن الاستجابة إلى هذه الحاجة، وخصوصا الجامعات التونسية.
وهذا اليوم الدراسي المنعقد في سوسة بعنوان Enseigner la literature de jeunesse a l’universite tunisienne. وفي رأيي أنّ هذا اللقاء لبنة أساسية في طريق طويل يجب أن يبدأ لإقرار تدريس أدب اليافعين في جميع مراحل تعليمنا من الابتدائي إلى الثانوي إلى العالي ضمن جميع مراحله وخصوصا الماجيستار والدكتوراه.
الورقة العلمية:
فجأة ولد جابر الرّاعي الذي سيصبح بعد ثلاثين عاما بطلا لكتابي الأوّل حكايات جابر الراعي الفائز بجائزة الشارقة للرواية العربية 2015، وبطل روايتي الثانية الطائر البشري الذي فاز هو أيضا بجائزة كتارا للرواية العربية 2017. وجابر الراعي هذا ورد على ذهني في وقت مبكّر من طفولتي في قصّة عنوانها جابر عثرات الكرام، أتذكر القصة بتفاصيلها، فهي لم تكن قصة بديعة، بل هي عمل أخلاقي وعظي يستعمل الحكاية. وملخصها أنّ صاحب المعروف وفاعل الخير لا يقع في المآزق، وإن حصل ووقع فيها فإنه سوف يجد من يساعده ويقف إلى جانبه.
الآن أحاول أن أكمل روايتي الثالثة التي يقوم جابر ببطولتها أيضا وهي بعنوان أقنعة أيسوب. “عشرة عمر” أنا وجابر هذا، يلازمني مثل ظلّ، وخلال السنوات الماضية كبرت أنا وإيّاه. وكثيرا ما أخاطبه بالقول: “متى ستتركني، وتذهب؟”. يتقن جابر الكلام، وهو من أمهر الناس في قصّ القصص، لكنّه لا يجيبني خارج الكتاب! وأنا وجابر يجمعنا أمر هو حبّ الحكايات. حين التقينا في الكتاب الأوّل حكينا 28 حكاية، كان جابر وقتها في سنّ الثلاثين ولكنّه يبدو طفلا على أبواب الشباب! قال لي في لقائنا الأول حين أنقذته من قطاع الطريق: “احملني معك ولن أكلفك شيئا. تردّدت، وحاولت التملّص، لكنّه قال لي كلمة لا تزال تتردّد في بالي: “أحملني معك وسوف أحكي لك كل يوم حكاية، وإذا لم أحك لك، اتركني!”. كنت في ذلك الوقت المبكر من حياتي تاجرا جوّالا، وكنت محبّا للحكايات، أبيع ثروتي كلها من أجل قصة تخلعني من عوالم المال الباردة. وسرنا معا. ونحن نمشي قال لي إنّ في حياته سرّا، وإنه محتاج لصديق صدوق، وبحاجة لشهرزاد صاحبة التفاحات السبع التي تغني، وأخبرني أن هناك شرطا ثالثا لا يعرفه! الشرط الأول تحقّق، فلقد كنت صديقه الصدوق، ووجدنا شهرزاد الصغيرة التي بحجم إصبع صغير، في نصف تفاحة، واضعناها، ووجدناها من جديد، وبقي الشرط الثالث ليستعيد جابر الراعي عمره المتوقّف. واكتشفنا الشرط ونحن نحيا ونطوف البلدان. فمع كلّ حكاية كان جابر يكبر، وكان شهرزاد أيضا تستعيد حياتنا بالحكي.
في ذلك الوقت المبكر في حياتي استعدت صلتي بالحكي بوصفه قوّة تحرير خارقة. وما الغريب؟ لقد عاشت شهرزاد ألف ليلة وليلة لأنها حكت! وكبر جابر، وكبرت شهرزاد، وصرنا عائلة. في الأثناء استقام لي أنا أيضا القصّ، فحكيت قصّة جابر الراعي بتمامها، وكما أخبرتكم سابقا فاز بجائزة عربية بوصفه كتابا لليافعين، وما كتبته أنا لهذا الأمر، ولا ورد ببالي. فما أبعدني أنا نصر سامي عن حكي القصص؟ وحكيها لليافعين؟ فأنا في رواياتي الأيات الأخرى والعطار وبرلتراس أروي قصصا معروفة النهايات منذ البداية. فلقد رويت قصة والد المسيح في الكتاب الأول، ورويت قصة العطار الذي تزوج بأكثر من 25 امرأة في رحلة الخلاص، وحكايته بدأت بخاتمتها. وفي برلتراس أدمجت الحكوي في الواقعي ليشهد الافول التدريجي لكلّ ما هو إنساني، ويرى كيف تحيون البشر!
وعادني جابر بعد سنتين وقد تحوّل طائرا حقيقيّا، وقد كاد حبّ الحكي نتيجة الاسترخاء والراحات الطويلة أن يخفت ويضيع. ولكنّ الطائر خاطبني وقال لي: “أيها العظيم، أنا بحاجة لشروط ثلاثة لأستعيد بشريتي”. ولست أنوي أن الخّص لكم روايتي بالطبع، ولكننا روينا أيضا قصصا كثيرة تتجاوز الثلاثين، وخلالها استعاد جابر بشريته! قال لي: “خلاصنا في الحكايات”. وصادقت على كلامه. كيف لا أفعل وقد شاهدته طيرا ثم شاهدته بشرا؟ الغريب في الأمر أنه في نهاية 2017 فاز الكتاب بجائزة كتارا للرواية العربية. وبدأت تظهر كلمة يافعين في بعض رواياتي، دون أن أكتب شيئا لليافعين! قالت لي الناشرة الإماراتية وقد رأت رفضي لذلك التصنيف: ” سأكتب في الملصق الإعلامي رواية يقرؤها من عمره 8 إلى 88″. كان ذلك يعني فعلا أنّ ما أكتبه لا يخاطب شريحة بعينها، بل يخاطب الإنسان! وبعيدا عن ذلك كله تزوج جابر من شهرزاد وأنجبا ثلاثة أولاد، وقدم علينا الزيني الكاتب وقارئ الكتب القديمة، وعارم زوجتي، وأولادي الثلاثة، ثم أصبح لنا وطن صغير اسمه الفجّ، وتكاثر الناس. ثمّ غاب جابر في معتاد حياة الناس، حتى هدّد الجفاف الفجّ وأهل الفجّ، فقام هو وأنا والزيني والطلياني وسليمة بمحاولة إنقاذ الأرض، لكن تحصل أمور كثيرة تنتهي بموت البشر لأنهم سبب خراب العالم، ولكن الحياة تستمر دون بشريين.، أو ببشريين محقونين بمحتوى غير المحتوى البشري. ويأبى هذا الكتاب الثالث أن ينتهي، ويصبح جابر شخصا واقعيا أشدّ واقعية ممّن عشت معهم عمرا.
الآن أنا وجابر صديقان، متقاربان في العمر، وأبوان لعديد الأبناء، وحكاياتنا تعيش فينا. وهكذا سرت في الوجود. كل حكاية هي حكايتي، جميع حكايات ألف ليلة هي حكاياتي، حكايات أيسوب المئة هي أيضا حكايتي، حكايات إبتالو كالفينو حكاياتي أيضا. صرت مدرّبا على تشرّب تلك النصوص الصغيرة التي بلا راو معلوم، وانفتحت لي في ذلك التراث الكوني مساحات تأسيس أعتقد أنها من الدروب التي تصلح أن تتّبع، وهو تسريد المرويّات الشفوية، ووسّعت الدائرة لتشمل المرويات الكبرى مثل شعر المفضليات وهو أقدم كتاب شعري عربي، أو ملحمة جلجامش، أو النصوص المقدسة. وهو موضوع يطول فيه الحديث.
البارحة أكملت كتابة 35 ألف كلمة من الكتاب الثالث الذي يرافقني فيه جابر الراعي، ستصل به إلى ال 50 كلمة! يقول لي، وأسمعه يضحك. ضحك الشخصيات الورقيّة لم يعد يقلقني! ما يقلقني حقّا هو الخبرات العميقة التي تسري في الجلد ونحن نقرأ أو نكتب، ما يحيرني بحقّ هو تلك الأضواء الخالدة التي يتشرّبها الجسد والروح. بحيث لا تصبح أنت بعد الحكاية أنت. تتوالد فيك نجوم، وتبزع شموس، وتتدلّى أقمار. أمن أجل ذلك أنا إنسان؟ ما القوّة التي للكلمات؟ ما السحر الذي للحروف؟ لا يحضرني جواب. أسئلتي في الغالب فؤوس صدئة مرمية على حافة الليل!
أدب اليافعين الذي أدرجت فيه بعض كتبي هو أدب روائي من الدرجة الأولى التي تكون فيها الفنون فنونا. تماما مثل مذهّبات العرب وأسماطهم. تكتب لليافع ولغير اليافع. وفي رأيي ما من أدب يافع، بل أن نصوصا كثيرة مثل العطر لباتريك زوكند أو الجميلات النائمات لياسوناري كواباتا أو الخيميائي أو لباولو كويلهو أو الشيخ والبحر لأرنست هيمنغواي هي أعمال لليافع ولغير اليافع. بل أن سيرا كثيرة قديمة وجديدة هي من تلك الآداب التي هي موجهة للقارئ. ولي في مسألة هذا النوع الادبي رأي أميل فيه إلى اعتبار كلّ أدب رفيع حرّ أدبا يصلح لليافع وغير اليافع، وكل أدب ينزع إلى الحدّ من مساحات التحرّر بفعل الدين او الأخلاق التفعية أدبا لا يصلح لليافع ولا لغير اليافع.
وأنا بهذا المعنى أكتب رواية غير حذرة في كلّ مستوياتها، وهي في الغالب لا تقدّم فائدة نفعية كيفما قلّبتها، وتتبرّا من الوعظ والإرشاد، وتنزع إلى الفنتاستيك، فأنا أنطق الجماد والحيوان وأمسخ المخلوقات وأحولها، وأنسب لها قدرات خارقة، وأستدعي مخلوقت عجيبة، وأوظف الحلم والتنجيم، وأفتح الشرد على الشروط المعجزة والتحديات الصعبة، وأستعمل وسائل الحكايات الشعبية ذاتها مثل العصى السحرية وقناع التخفّي وحجر الساحرات وإبرهنّ، والمكانس الطائرة. تأتيني تلك الأمور بيسر باعتبارها أمورا ترقد في قعر علبة الأدوات الخاصة بي، ولا يجب عليّ إهمالها.
وفي غفلة من الزمن كتبت 50 قصة متوسطة الحجم ستصدر في سلسلة قصصية سميتها مكتبي الخضراء الملونة. (صدر منها ثلاث قصص). وددت فيها أن أكتب بكامل أدبيتي، وتحرّري الفكري، وبحضور عميق لشعريتي، مع شبكة تناصات متنوعة. وبذلك أحمي نصّي من النزول إلى قارئه، وأمتنع بسبب شروط الجنس الأدبي عن تطهير نصّي مما يجعله حقيقيّا وصادقا، وأمتنع عن السذاجة. إنّ مشكلة ما يسمّى أدب اليافعين هو أنّ من يحدده هم الكبار ومن يكتبه هم الكبار ومن يسيّجه بأمور ستؤدّي لفنائه هم الكبار أيضا. أمّا أنا وصديقي جابر فإننا كتبنا كتبا للإنسان يافعا وغير يافع.
وفي ختام شهادتي أصل إلى القناعة التالية: إن لأدب اليافعين عديد العوائق لعلّ أهمّها أدب اليافعين الذي يكتبه الكبار، فهم يكتبونه معتقدين أنهم يسدون نقصا، وهذا التصور يرى في اليافعين شبابا قليلي الخبرة وقليلي التركيز وضحايا ضغوط المجتمع وقليلي الثقافة وجهلاء بقواعد الكتابة. ولذلك يتدخل الوصيّ ليكتب للغرّ، في عمل ظاهره خير وباطنه مراجل شر. قد أبدو متشائما، لا بالقطع، فحسب رأيي أدب اليافعين له أفاق كبيرة تقيه من الفناء في غيره والاندثار. منها أن يعود إلى كتّابه الحقيقيين وهم اليافعون ذوو التعبير الفريد، والقادرون على استعمال التكنولوجيا، وعلى تنويع تجاربهم الثقافية والسياسية والاجتماعية وعلى التأثير القوي في مجتمعاتهم. وغني عن القول إن اليافع أسرع من الكهل في تمثل التطور والاستمرار فيه.
مقومات فنية وتربوية لأدب اليافعين:
هناك مغالطة تريد أن ترسّخ فينا فكرة خاطئة وهي أنّ أدب اليافعين أو الشباب هو اختراع جديد، وأنه يحظى بعناية كبيرة في المجتمع الحديث بسبب جدّته، والحقيقة أنّ هذا خطأ بيّن وكبير إذ أن التراث العربي اهتمّ كثيرا بهذه الفئة ويظهر ذلك في اهتمام بعض الخلفاء يتعليم أبنائهم فجلبوا لهم أفضل المعلمين وقد حاول هؤلاء أن يعلّموا أولادهم بواسطة الرواية رواية الأشعار وقص الحكايات وسرد قصص الصالحين وترجمة الحكماء والمفكرين. ومن مآسي ثقافتنا الحاضرة أنّ مفهوم أدب اليافعين لم يبرح هذه الدائرة فنحن تقريبا نتحرك في هذه الدوائر ذاتها. فنحن نعيد ونعيد ونعيد ولا نتوقف عن التعليم والتربية بواسطة أنموذج هو غالبا أنموذج مستمدّ من قالب حكائي قديم وإن حاول إيهامنا بالمغايرة الأسلوبية أو المضمونية.
ومن شواهد ما قلناه كتاب المفضليات وهو أول كتاب شعري عربي جمعة المفضل لتعليم ابن الخليفة في زمانه. ومن المشهور قول عبد الملك بن مروان: “علّمهم الشعر يسمحوا ويمجدوا وينجدوا وجنبهم شعر عروة بن الورد فإنه يحمل على البخل”. وقال أيضا: “أدّبهم برواية الأعشى، فإنّ لها عذوبة يدلهم على محاسن الأخلاق”. السؤال هنا: هل خرجنا نحن كتّاب اليوم عن إطار هذه الرؤية؟ القدامى يرون أنّ الأدب يربّي ويعلّم القيم ويلقّن الأخلاق، ولكنّه أيضا يرفّه ويسلي ويمضي وقت الفراغ. لكن لأمر ما لم يخصّص العرب الأوائل لهذا الأدب تصانيف وكتبا، وذلك عائد إلى عدم حاجتهم في بيئتهم تلك إلى نوع جديد، وربّما كانت لهم نظرة استهانة تلحق هذه الآداب بالأدب الشعبي. ولهذا دوّنوه وأدرجوه في أدب الكبار. أمّا اليوم فإنّنا نجد أدبنا الموجّه للأطفال والشباب واليافعين مثل أدب أسلافنا محقّقا لوظيفتين أساسيتين هما الإمتاع والمؤانسة على رأي التوحيدي.
وكثرت التصانيف وتنوّعت، بل أننا لاحظنا محاولات جدية للخروج من هذه الرؤية لدى قلة قليلة من الكتاب ممن حاولوا التعبير عن قضايا المراهقة التي تطرح بعيدا عن دوائر الوعظ والإرشاد وكتابة نص يطرح مشاكل الطفل والشاب واليافع. وبما أنّ الأنموذج الأصلي لرواية اليافعين غربي أساسا فإنّنا منذ بواكير كتبنا منذ النهضة إلى اليوم نراوح في النصّ الأنموذج المترسّخ في الثقافة الغربية والدائر أساسا حول كتاب المغامرات والحكايات. وهي كتب أصيلة رائعة في سياقها وفي رؤياتها المناسبة للمجتمعات التي وجدت فيها أما عندنا فإنها روايات غير أصيلة مقحمة إقحاما في ثقافتنا. وهذا حديث يطول ربما نجد فرصة غير هذه لنتبادل فيه الرأي.
في ختام شهادتي في ملتقى دولي انعقد في كلية الآداب بسوسة بالاشتراك مع إحدى الجامعات الفرنسية حول أدب اليافعين وعنوانه Enseigner la littérature de jeunesse à l’université tunisienne قلت فيه: “إن لأدب اليافعين عديد العوائق لعلّ أهمّها أدب اليافعين الذي يكتبه الكبار، فهم يكتبونه معتقدين أنهم يسدّون نقصا، وهذا التصوّر يرى في اليافعين شبابا قليلي الخبرة وقليلي التركيز وضحايا ضغوط المجتمع وقليلي الثقافة وجهلاء بقواعد الكتابة. ولذلك يتدخل الوصيّ ليكتب للغرّ، في عمل ظاهره خير وباطنه مراجل شر”. وبهذا القول أمرّ الآن إلى مقوّمات هذا الأدب وأهدافه لأطرح حولها بعض الأفكار.
إنّ هذه المقومات هي غريبة الغرائب لدى الكتّاب العرب. إذ أنّهم يجعلون لأدب اليافع مقوّمات أقلّ اتساعا وشمولا من مقوّمات أدب الكبير. فعلى الكاتب لليافعين أن يراعي طبيعة هذه الفئة. ومن أجل نجاح الأمر فلا بأس من التضحية ببعض المقومات. وعليه أن يرضي هذه الفئة ويستجيب لتطلعاتها ويتواءم مع حساسية هذه المرحلة، ولا بأس أن يضحّي ببعض الأمور الأدبية لينجح في مسعاه. والنتيجة أنّ أغلب ما يكتب هو مسخ أدبي غير أصيل وغير أدبي ومحدود جدا من حيث مقوّماته الأدبية. إنّ كتّاب أدب اليافعين العرب حسّاسون جدا في مسألة المقوّمات المحدّدة للنّوع، وحريصون جدا على الانضباط وعدم الخروج، ولا يملّون من التخلّي الأدبي عن الأساسيات في سبيل قارئ متوهّم يرون أنّه يستحقّ النزول إليه.
وبالحق فإنّ أمام الكاتب العربي عقبات كثيرة ناتجة أساسا عن طبيعة تمثله للأدب عموما وللأدب الشبابي تحديدا. ونضرب مثالا على ذلك قول الكاتبة الفائزة بجائزة كتارا سناء شعلان في قولها: “يحتاج هذا النوع من الكتابة إلى مبدع مدجج بالمعرفة والثقافة العامة التي تؤهله للدخول في عوالم الطفل بأبعادها جميعا، مع القدرة على التعاطي معها بذكاء وحرفية مع وجود خطة تربوية وأخلاقية وجمالية واضحة ومنسّقة”. وهذا كلام جميل في ظاهره أما في عمقه فهو الدعوة إلى توفر سياسة تنازل عن بعض المقومات الأدبية التي قد تعيق التربية والأخلاق والجمال والاتّساق والوضوح. وبالتتابع فإنّ الكاتب العربي يجب أن يراعي… وهو مطالب…. وهو مدعو إلى تجنب… وهو وصيّ على…. والنتيجة أنّ الكاتب العربي في الغالب يكتب لليافع رواية مخصوصة تتحرّك ضمن جماليات شديدة الانحسار مقارنة بجماليات رواية الكبار بسبب محاذير كثيرة منها سوء تقديرهم لمستويات اليافع وطبائعه وثقافته ومواكباته لعصره وهذا أمر متغيّر.
نقطة أخرى من المهمّ قولها ولا أحبّ أن ينزعج منها زملائي كتاب اليافعين، وهي أنّ غالبية من يكتب هذا النوع كتّاب لا موهبة حقيقيّة لهم، وليس لهم نصوص مهمّة في أنواع أخرى مثل الشعر والرواية والتفلسف وخلوّ هذه النصوص من العمق المتوجّب لها بسبب أنّه ليس لكتابها القدرات العلمية والثقافية والتجربة والاختصاص. وهنا لديّ عشرات السلاسل التونسية التي أعتبرها شخصيا جرائم ضد أدب الأطفال واليافعين وضد الإنسانية.
والكاتب العربي يراعي سنّ الشباب فيتنازل عن أمور ويطرح القضايا التي تهم الشباب لكنه يطرحها بشكل مخصوص، ويهمل في أكثر النماذج التي نظرنا فيها الفلسفة وعلم الاجتماع والفنون والسياسة الدولية وقضايا الجنس والدين والسياسة. لا أريد أن أبدو فضّا أو متشائما، ولكنّ الوضع وضع أدب الأطفال واليافعين قاتم. وما يدفعني إلى ذلك هو خلو المكتبة العربية من نصوص لليافعين تشتغل في هذا المجال بجميع مقوّمات النوع الأدبي. ولهذا نجد كتبا تبالغ في الالتزام بالمحاذير، فتكون رواية قصيرة ويمنع أن تكون طويلة، ويستحسن تبسيط البنية، ويجرّم التعقيد والتركيب والتجريب بالطبع، ويستحب فيها أن تكون مفهومة ويطرد منها كل نصّ غامض غير مفهوم! ولقد لجأ أغلب كتّاب هذا النوع إلى الخيالي. وقد قادهم ذلك إلى مأساة حقيقية وهي انتزاع مخيالات مرتبطة بظروف معينة (ثقافية إثنية خرافية أسطورية رمزية) ومحاولة إدراجها القسريّ في سياق الواقعي والمحلّي. ولقد حاول آخرون تطوير هذه الفعالية في اتجاه الفنتاستيك أو العجائبي. وحاول بعضهم أن يضحك الصبيان أو أن يثقّفهم ويجعلهم يعتزون بثقافتهم وأنتجت هذه الأمور روايات كثيرة هي في رأيي بعيدة عن الأدبية.
أنا أيضا أتحرّك باعتباري كاتبا عربيا ضمن هذه الحدود، ولعلّي أداور في أسلوبية ألف ليلة وليلة دون أن أصل إليها. وذلك بسبب أنّ راوي الليالي ليس واحدا بل كثير، وليس له محاذير بل لعله من أكثر رواة الأدب تحرّرا، ولا يتحرّك في أدبية محدودة بل لعله من أكثر الرواة تنويعا. وهو أخير ليس كتابا أخلاقيا تربويا وعظيا بل هو نص ساحر لا زمني تتحقق فيه الأدبية في إطلاقها. أمّا رواية اليافعين العربية فإنها تعاني وتئنّ تحت نير محاذيرها.
فهم يلجؤون إلى التضمين enchassement وهو آلية عبقرية لكنها عندنا آلية إدراج آليّ استيعابي انتقائي لنصوص الغير أو للتراث الحكائي والكاتب العربي يمارس مع قرّائه إيهاما بالتغاير، ولا يقوم بالتغاير فعليا مع تلك البنى الحكائية المغلقة. ومن المقوّمات الأخرى الشخصيات وهي في الغالب موظفة بعناية لتربّي الطفل بالشّبيه. ومن المقومات الأخرى الفانتاستيك، فلقد حاول الروائيون العرب انطاق الجمادات والحيوانات وهذا ليس جديدا، وعمدوا إلى استعمال المسخ والتحول وهذا أيضا ليس جديدا، ولجؤوا إلى القوى الخارقة وهذا معاد ومكرر، وعمدوا إلى العجيب والحلم والتنجيم والشروط المعجزة. وهي أمور مهمة لكنها تحضر في النصوص الروائية كحضورها في الحكايات الأصلية، بل تقصر عنها، بحكم أن للحكاية نظاما شديد الاتّساق والنظام ولا زمن له وراويه غالبا الضمير الجمعي لذلك يبدو في الحكايات مصهورا بنار الحكمة وعبق الحضارة، ويبدو في الروايات تلفيقا، وذلك لأنّ نظم الحكاية وبناها من الدقّة بحيث يصعب الخروج منها إلى غيرها.
وأخيرا فإنّ أدبا لا تهتمّ به المدرسة العمومية، ولا يهتمّ به المعهد، ولا تهتمّ به الجامعة، وهو مقصى تماما من مجال التداول العلمي في جميع كليات الآداب وغيرها من الكليات (الفلسفة وعلوم الاجتماع)، لا يمكن أن نتحدّث عنه بوصفه نوعا متحقّقا، بل هو مشروع طموح يجب أن نشرع في مراكمته ودراسته والبحث في واقعه وآفاقه.
مجلة قلم رصاص الثقافية
 مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.
مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.