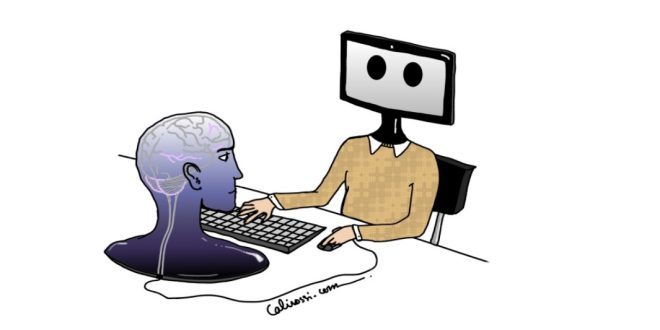س: كتبت إحدى الصديقات في مقالة أدبية:
في حكاية العصفور المبرقش لجيرزي كوزينسكي يصطاد “أطفال بولنديون العصافير، ويلونون ريشها، ثم يطلقون سراحها. حين تعود العصافير إلى حريتها تلحق بسربها، فلا تتعرف إليها العصافير الأخرى، فتهاجمها وتقتلها”. وهذا ما يستدعي ضمنًا حكاية عصافير كثيرة قتلها اختراق النظام الثقافي (مأساة الحلاج، سلخ فروة رأس عماد الدين نسيمي، محنة ابن رشد)
هل المعلومات الواردة في النص صحيحة؟
ج: نعم، هذه المعلومات دقيقة في سياق رمزية رواية العصفور المبرقش للكاتب البولندي جيرزي كوزينسكي. الرواية، التي صدرت عام 1965، تصور قصة طفل صغير يتنقل عبر الريف البولندي أثناء الحرب العالمية الثانية، محاولًا النجاة من القسوة والوحشية. أحد المشاهد الشهيرة في الرواية يتضمن حكاية “العصفور المبرقش”، حيث يلون أطفال بولنديون ريش أحد العصافير ثم يطلقونه. عند عودته إلى السرب، تهاجمه العصافير الأخرى حتى الموت، لأنه بات غريبًا عنها.
هذه الحكاية تعمل كرمز قوي في الرواية، تجسد فيها معاناة البطل نفسه كـ”غريب” يتم رفضه واضطهاده من قبل من حوله. وهي تمثيل للأذى الناجم عن نبذ الاختلاف واختراق الأنظمة الثقافية أو الاجتماعية.
الإسقاط الذي يربط مأساة العصفور المبرقش بحكايات الحلاج، نسيمي، وابن رشد هو تأويل دقيق، يعكس مصير الشخصيات التي اخترقت “النظام الثقافي” أو الديني في مجتمعاتها: الحلاج: الفقيه الصوفي الذي أُعدم بعد اتهامه بالزندقة، يمثل مثالًا على رفض المجتمع للأفكار الجديدة الخارجة عن المألوف، ونسيمي، الشاعر الصوفي الذي أُعدم وسُلخت فروة رأسه بسبب آرائه الدينية التي خالفت السياق التقليدي.، وابن رشد: الفيلسوف الأندلسي الذي اضطُهد بسبب فلسفته العقلانية وتعارضه مع تيارات الفكر التقليدي في عصره.
س: هل هي حقيقة علمية إذاً أن الطيور تهاجم طائراً منها تم تلوينه بشكل مختلف؟
ما يدفعني للسؤال هو أن الطيور تتعرف على بعضها بطرق أخرى غير النظر!
ج: لا يوجد دليل علمي مباشر يدعم فكرة أن الطيور تهاجم طائرًا تم تلوين ريشه فقط بسبب مظهره المختلف، خاصة وأن الطيور تعتمد على عوامل متعددة للتعرف على أفراد جنسها، مثل الصوت، الحركة، والسلوك، إلى جانب الشكل البصري. ومع ذلك، هذه الفكرة يمكن أن تكون مستوحاة من ملاحظات أو تجارب فردية أو سيناريوهات مختلقة لأغراض رمزية.
إن الطيور تتعرف على أبناء جنسها بواسطة الصوت والعلامات البصرية بالإضافة للسلوكيات والحركة.
أما حالات الهجوم بين الطيور فتحدث إذا كان هناك تداخل في المناطق الجغرافية أو تنافس على الموارد. كما أن السلوك العدائي يمكن أن يحدث في سياقات مختلفة، مثل الدفاع عن العش أو التنافس على الشريك، ولكن ليس بالضرورة بسبب تغيير في لون الريش فقط.
س: هل الأدب إذاً، خيال يزيف الحقائق، كما فعل النص السابق؟
ج: الأدب ليس مجرد خيال يزيف الحقائق، بل هو وسيلة تعبير فنية تستعير من الواقع وتحوله إلى رموز، قصص، وأفكار. الأدب قد يستخدم الخيال لتقديم رؤى أعمق عن النفس البشرية والمجتمع، وليس الهدف منه عادة تقديم الحقيقة العلمية أو المادية كما يفعل العلم. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه “يزيف” الحقائق بشكل متعمد؛ بل هو يعيد صياغتها ليخلق تجربة جمالية أو ليحمل رسالة فكرية.
إن الأدب قد يقدم سيناريوهات خيالية، لكنها تستند إلى أنماط إنسانية أو مجتمعية واقعية. كما فعل جورج أورويل في 1984 فهو لم يقدم حقيقة عن المستقبل، لكنه استشرف كيف يمكن أن تتطور الديكتاتوريات.
إن العديد من الأعمال الأدبية تعتمد على الرمزية، مثل حكاية العصفور المبرقش. قد لا تكون هذه القصة قائمة على حقيقة علمية، لكنها ترمز إلى معانٍ أعمق تتعلق بالاختلاف، النبذ، والاضطهاد.
في بعض الأحيان، الأدب يستخدم “تزييف” الحقائق بشكل متعمد ليبرز المفارقة أو لينتقد ظاهرة معينة. على سبيل المثال، الحكايات الأسطورية تبالغ في خصائص الأبطال لكنها تعكس قيمًا مجتمعية أو أخلاقية.
س: لنتحدث عن علاقة الأدب بالحقائق العلمية!
ج: إن الأدب يهدف إلى إثارة المشاعر وتقديم تأملات، بينما العلم يسعى إلى تفسير العالم بمصطلحات دقيقة يمكن التحقق منها. يمكن للأدب أن يطرح تساؤلات فلسفية أو أخلاقية حول الحقائق العلمية. مثال: روايات الخيال العلمي، مثل أعمال جول فيرن، التي كانت تستند إلى العلم لكنها تجاوزته بخيال واسع.
إن الأدب ليس أداة زيف، بل وسيلة إبداعية لاستكشاف الحقيقة بطرق غير تقليدية. الفرق الأساسي بين الأدب والعلم هو أن الأول يعتمد على الخيال والرمزية لفهم المشاعر والتجارب الإنسانية، بينما الثاني يعتمد على الملاحظة والتحقق لفهم العالم المادي.
لذلك، الأدب لا يسعى لإثبات أو دحض الحقائق، بل لإعادة صياغتها بأسلوب يجعلها أكثر تأثيرًا.
س: هذا يقود إلى سؤال، لماذا يصدق الناس الأدب أكثر من تصديقهم للحقائق العلمية؟
ج: الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تحليلًا يجمع بين الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية لتفسير القوة التأثيرية للأدب مقارنة بالعلم.
الأدب ينجح في الوصول إلى عقول البشر بسبب قدرته على تحفيز المشاعر بشكل مباشر، مما يجعله أكثر تأثيرًا من الحقائق العلمية المجردة. القصص الأدبية تتيح للمتلقي تجربة وجدانية حية، حيث يعيش الأحداث عبر عيون الشخصيات، مما يعزز شعوره بالتعاطف والانتماء. على العكس، الحقائق العلمية تُقدَّم غالبًا بلغة تقنية وجافة يصعب على العامة تفاعلهم العاطفي معها، مما يجعل تأثيرها أقل. على سبيل المثال، روايات مثل كوخ العم توم لعبت دورًا محوريًا في تشكيل الوعي حول قضايا العبودية، بطريقة أكثر تأثيرًا من النقاشات العلمية والاجتماعية في ذلك الوقت.
إضافة إلى ذلك، يعتمد الأدب على أسلوب سردي بسيط ومباشر، يسمح بتوصيل الأفكار المعقدة بطريقة تسهل فهمها وتذكرها. في المقابل، يعاني العلم من كونه معقدًا وصعب الفهم للجمهور العام، إذ يتطلب تفسيره استخدام مفاهيم متخصصة وبيانات تجريبية دقيقة. هذا التبسيط في الأدب يقود إلى ترسيخ الرسائل التي يقدمها في عقول الجمهور، حتى وإن كانت هذه الرسائل غير دقيقة.
من ناحية أخرى، طبيعة الإنسان الميّالة لتقبل السرديات تعزز من مكانة الأدب. فالقصة كانت ولا تزال وسيلة البشر لفهم العالم وتنظيم خبراتهم. هذا النمط من التفكير يجعل الناس أكثر ميلًا لتصديق القصص الأدبية لأنها تتبع تسلسلات منطقية وروابط عاطفية. حتى عندما يتضمن الأدب مبالغات أو تحريفات، يُنظر إليه باعتباره يحمل “حقيقة عاطفية” أقوى من الحقيقة العلمية.
الأدب أيضًا يحمل سلطة رمزية تعزز مصداقيته. العديد من المؤلفين يتمتعون بمكانة فكرية واجتماعية، مما يجعل أعمالهم تُعامل كمرجعيات ثقافية. تُضاف إلى ذلك تحديات التواصل العلمي؛ إذ يعاني العلماء من إيصال رسائلهم إلى الجمهور بسبب تعقيد اللغة العلمية. حتى عند تقديم العلوم في الأدب كما في الخيال العلمي، غالبًا ما يُكيف الكتاب الحقائق لتناسب الحبكة، مما يساهم في تشويه المعرفة العلمية مع الحفاظ على التأثير العاطفي.
يصدق الناس الأدب لأنه يخاطب العاطفة ويعكس تجارب إنسانية مشتركة، بينما يتطلب العلم تفاعلًا معرفيًا بحتًا، وهو أقل جذبًا للجماهير. لفهم أعمق لهذه الظاهرة، يمكن الرجوع إلى أعمال مثل ليوفال نوح هراري التي تناقش أهمية السرد في تشكيل التاريخ الثقافي للبشرية، وكذلك أبحاث علم النفس حول تأثير السرديات على الوعي الجمعي.
س: لننطلق إلى سؤال أكثر تحديداً، ما وظيفة الأدب؟
ج: الأدب يُعد من أهم وسائل التعبير الثقافي والفكري، وله وظائف متعددة تتجاوز مجرد التسلية أو الترفيه. يمكن تصنيف هذه الوظائف في عدة مجالات أساسية:
– التعبير عن التجارب الإنسانية الأدب يعكس تجارب البشر الفردية والجماعية، سواء كانت من واقع الحياة اليومية أو من خلال الخيال. يقدم الأدب للقراء فرصة لاستكشاف مختلف جوانب الوجود البشري، من الحب والصراع، إلى الأسئلة الكبرى حول المعنى والهدف.
– نقل القيم الثقافية والأخلاقية يعمل الأدب كأداة لنقل القيم الثقافية والأخلاقية من جيل إلى جيل. من خلال القصص والروايات، يتم نقل تجارب الحياة المتنوعة، مما يساعد على تشكيل الهوية الثقافية للمجتمعات.
– التأثير الاجتماعي والسياسي لقد كان الأدب، على مر العصور، وسيلة رئيسية للتأثير على المجتمعات والأفراد. من الأدب الثوري إلى الأدب الذي يعكس الصراع الاجتماعي، نجد أن الكتب والروايات يمكن أن تسهم في دفع التغيير الاجتماعي والسياسي. على سبيل المثال، كتب مثل 1984 لجورج أورويل تقدم تحليلات نقدية للأنظمة السياسية.
– توفير الراحة النفسية والتسلية جانب آخر مهم من الأدب هو دوره في توفير الراحة النفسية والتسلية للقراء. من خلال القصص والشعر والمسرح، يمكن للأدب أن يتيح للقراء الهروب من ضغوط الحياة اليومية.
– التوجيه الفكري والفلسفي الأدب أيضًا يقدم مادة للتفكير الفلسفي والتوجيه الفكري، حيث يطرح الأسئلة حول القيم والأخلاق والوجود.
س: اذكر لي أمثلة تاريخية ومعاصرة حول تأثير الأدب في تمرير الأيديولوجيات.
ج: الأدب كان دائمًا وسيلة فعّالة لتمرير الأيديولوجيات والتأثير في تشكيل الوعي الجماعي، سواء في الماضي أو الحاضر، ففي العصور الوسطى، قدّمت “الكوميديا الإلهية” لدانتي أليغييري رؤى دينية وفلسفية تنتقد فساد الكنيسة وتُروّج لأفكار مسيحية محددة، كما طرحت “المدينة الفاضلة” لأفلاطون رؤية فلسفية للنظام الاجتماعي والسياسي المثالي، وهي أفكار أثرت لاحقًا على حركات أيديولوجية متعددة. وفي العصر الحديث، ساهمت أعمال مثل “1984” و”مزرعة الحيوانات” لجورج أورويل في انتقاد الأنظمة الشمولية الاستبداد، مما جعلها رمزًا أدبيًا للحريات الفردية وحقوق الإنسان.
في العالم العربي، كان الأدب وسيلة للتعبير عن الأيديولوجيات القومية والتحررية. عبّرت رواية “عودة الروح” لتوفيق الحكيم عن روح القومية ودعمت ثورة 1919، بينما ركّز أدب غسان كنفاني على القضية الفلسطينية وأصبح أداة أدبية لدعم أيديولوجية المقاومة والتحرر. أما “موسم الهجرة إلى الشمال” للطيب صالح، فقد تناولت الصراع الثقافي بين الشرق والغرب، وطرحت نقدًا للاستعمار وتأثيراته. في سياق آخر، كان لأدب ما بعد الاستعمار، مثل كتابات سلمان رشدي وتشنوا أتشيبي، دور كبير في إبراز قضايا الهوية وتأثير الكولونيالية، بينما ركّزت روايات إليف شافاق على أيديولوجيات حقوق الإنسان والتعددية الثقافية. سواء عبر روايات تمجّد الثورة أو تنتقد الأنظمة، يظهر الأدب دائمًا كقوة مؤثرة في تشكيل وعي الشعوب ونقل الأيديولوجيات عبر الأجيال.
س: كيف نربط ما قاله ميشيل فوكو من أن كل سلطة تنتج معرفتها وبين الأدب كوسيلة لتمرير الأيديولوجيا؟
ج: وفقًا لفوكو، السلطة والمعرفة مترابطتان، حيث تنتج السلطة معرفة تدعم وجودها وتشرعن هيمنتها، والأدب يعد جزءًا من هذا الإنتاج المعرفي، إذ يمكن أن يكون وسيلة لتمرير الأيديولوجيات عبر صياغة خطابات تعزز سلطة معينة أو تناهضها. عندما تدعم السلطة نصوصًا أدبية، فإنها تصوغ من خلالها معارف تُقدَّم للجمهور كحقائق تخدم مصالحها، كما هو الحال في الأدب القومي الذي يروج للانتماء ويعزز شرعية الدولة .
في المقابل، يمكن للأدب أن يكون أداة مقاومة، ينتج معارف بديلة تكشف أساليب السلطة في السيطرة، مثل رواية “1984” لجورج أورويل التي تعرّي المراقبة والتحكم. كذلك، فإن الرقابة على الأدب تُبرز مدى ارتباطه بالسلطة، حيث تُمنع النصوص التي تهدد الخطاب الرسمي. الأدب، بهذا المعنى، يمثل فضاءً لصراع الخطابات، كما يظهر في أدب الاستعمار الذي برر الاحتلال، مقابل أدب التحرر الذي كشف المعاناة وناهض الهيمنة. بهذا، يصبح الأدب أداة مركزية في إنتاج المعرفة، سواء لتعزيز السلطة أو لتحديها.
س: إذا كان الخيال عنصراً أساسياً في العمل الروائي، فلماذا تتم مصادرة بعض الأعمال الروائية؟ لماذا تمنع بعض الروايات؟ لماذا مثلاً تم في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب منع تكريم الروائية عدنية شبلي بسبب رواية “تفصيل ثانوي” وهي رواية خيالية تقدم وجهة نظر تحتمل الاختلاف او الموافقة؟
أعط إجابة شاملة موسعة مع أمثلة عن الروايات التي تم منعها أو حرقها أو مصادرتها!
ج: من بين أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى منع أو مصادرة روايات، نجد الاعتبارات السياسية والـ اجتماعية و الـ دينية. الروايات التي تثير قضايا خلافية أو تمس قوى حاكمة أو معتقدات دينية راسخة تُعتبر أحيانًا تهديدًا للأمن الاجتماعي أو السياسي. هذا قد يؤدي إلى منع النشر أو سحب الأعمال من الأسواق أو حتى حرقها. كما تتعرض بعض الروايات للرقابة عندما تتضمن تحريفًا أو إعادة تفسير للحقائق التاريخية أو الاجتماعية التي ترفضها الأنظمة الحاكمة أو بعض الجماعات المتطرفة.
رواية “1984” لجورج أورويل من أبرز الأمثلة على الروايات التي تم منعها أو حرقها في عدة دول، بسبب نقدها اللاذع للأنظمة الشمولية وسلطتها على الحقيقة، ورؤيتها للرقابة الجماعية والتحكم في الفكر. وفي العديد من الدول مثل الاتحاد السوفيتي سابقًا، كانت “1984” محظورة لأن المحتوى الذي تقدمه يتناقض مع الأيديولوجيات الرسمية.
أما بالنسبة لرواية “مئة عام من العزلة” للكاتب الكولومبي غابرييل غارثيا ماركيز، فقد كانت موضوعًا للرقابة في العديد من دول أمريكا اللاتينية في السبعينيات، حيث تعرضت للمصادرة لأنها كانت تتضمن نقدًا غير مباشر للأنظمة الحاكمة وللحالة السياسية في تلك البلدان.
أما في العالم العربي، فقد تم منع رواية “عزازيل” ليوسف زيدان في بعض الدول العربية، وهي رواية تاريخية تناولت مسألة الهوية المسيحية في العصور القديمة. كانت الرواية مثار جدل كبير لانتقادها لرجال الدين وبعض الممارسات التاريخية التي ارتبطت بالديانة المسيحية. لذلك، فإن المنع تم لأسباب دينية وثقافية، حيث اعتبر بعض رجال الدين أن الرواية تساهم في تشويه صورة الدين المسيحي.
فيما يتعلق برواية “تفصيل ثانوي” للكاتبة عدنية شبلي، والتي كانت موضوعًا للمنع من التكريم في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، يمكن القول إن القصة تتشابك مع قضايا سياسية واجتماعية حساسة. الرواية تستعرض العلاقات بين الأشخاص وتصور جوانب من الصراع الفلسطيني، وهو موضوع قد يكون محط اهتمام كبير من أطراف سياسية مختلفة. ربما كانت وجهة النظر التي قدمتها الكاتبة تتناقض مع المواقف السياسية لبعض الأطراف، مما دفعهم إلى منع التكريم كنوع من فرض الرقابة على الأعمال التي قد تساهم في تشكيل رأي عام معين.
تستند هذه الممارسات من المنع إلى مسألة الخوف من التأثير الثقافي أو الاجتماعي الذي قد تُحدثه الروايات التي تطرح أفكارًا قد تُعتبر تهديدًا للمعتقدات السائدة أو التي تثير جدلاً سياسيًا. ففي حالة مثل هذه الروايات، قد يتم اعتباره أن الخيال الأدبي يتجاوز الحدود المقبولة للمجتمع.
س: واضح ما أجبت به، لكن سؤالي بشكل آخر وبالتحديد:
كيف ينظر الجميع إلى الرواية كوثيقة تقدم حقائق دامغة؟ لماذا يتم تجاهل الخيال؟
لماذا يتم اعتمادها كنشرة حزب سري او تنظيم معادي ؟ وهي بالأصل والتسمية رواية خيالية؟ ما مصدر هذا خوف السلطة العظيم من الرواية؟
ج: الرواية، رغم كونها نوعًا أدبيًا خياليًا بامتياز، تُنظر أحيانًا من قبل القراء والسلطات كوثيقة تعكس حقائق دامغة، إذ تتداخل الأحداث الخيالية مع الواقع في الكثير من الأحيان، مما يجعلها تبدو كأنها تصوير حي لمواقف وأوضاع قد تكون مألوفة. في الواقع، الرواية تُعتبر مرآة للواقع، ولكنها في كثير من الأحيان تعرض هذا الواقع بطريقة مجازية أو رمزية، مما يؤدي إلى أن يراها بعض القراء كوثيقة تاريخية أو اجتماعية حقيقية. هذا التضارب بين الخيال والواقع يُسهم في جعل القراء يتعاملون مع الروايات وكأنها حقائق ثابتة، لأن الرواية تشكل سردًا مقنعًا للأحداث التي تتناسب مع تصوراتهم الشخصية، حتى لو كانت مبنية على خيال.
أما بالنسبة لتجاهل الخيال، فإن السبب يكمن في ميل الناس إلى تصديق السرد الذي يتناغم مع مشاعرهم وأيديولوجياتهم، خاصة إذا كانت الرواية تدور حول قضايا معروفة أو شائكة مثل السياسة أو الظلم الاجتماعي. في مثل هذه الحالات، تميل الرواية إلى تقديم تفسير مبسط ومؤثر للأحداث، مما يسهل على القارئ تصديقها كحقائق رغم أن جزءًا كبيرًا منها يعتمد على الخيال.
تكمن إشكالية الرواية الخيالية في أنها تُقدَّم في بعض الأحيان كأداة تحمل رسائل أيديولوجية أو سياسية خفية، وهو ما يجعل الأنظمة السياسية أو السلطات الحاكمة تراها تهديدًا لأيديولوجياتها. من هذا المنطلق، يمكن أن يتم حظر الروايات أو مصادرتها لأن النظام الحاكم يخشى من تأثير الرواية في تشكيل الرأي العام وتغيير الأفكار السائدة. فالروايات التي تحمل أفكارًا نقدية أو متمردة ضد الأنظمة السياسية غالبًا ما تكون عرضة للمصادرة، كما حدث مع العديد من الأعمال الأدبية في تاريخ الأنظمة الاستبدادية، مثل أعمال بوريس باسترناك في الاتحاد السوفيتي أو ألكسندر سولجنيتسين، اللذان عُرفا بمناهضتهما للنظام الشيوعي.
س: إذا كان الخيال أساسياً في الكتابة الروائية ،والتأريخ هو وجهات نظر غالباً تتقاطع مع الأيديولوجي غالباً؟ فكيف يجب النظر إلى الرواية التاريخية إذاً ؟ هل هي تقدم حقائق تاريخية؟ وما هي معايير ضبط ذلك؟
ج: الرواية التاريخية هي نوع أدبي يمزج الواقع والخيال، حيث تعتمد على أحداث تاريخية حقيقية لكنها غالبًا لا تقدم حقائق دقيقة بل تصورات خيالية عن الماضي. الخيال في الرواية التاريخية يُستخدم لخلق أحداث أو شخصيات غير مؤكدة تاريخيًا أو مستحيلة، مما يساهم في نقل رسائل أدبية وفلسفية.
على سبيل المثال، رواية “الحرب والسلم” لليو تولستوي تستند إلى أحداث تاريخية مثل معركة بورودينو، لكنها تركز على تأثير تلك الحروب على الأفراد والمجتمعات أكثر من تقديم سرد دقيق للأحداث العسكرية.
تقييم الرواية التاريخية يتطلب معايير مثل التوثيق التاريخي والانسجام مع السياق الاجتماعي والسياسي. يجب أن تعتمد الرواية على مصادر يمكن التحقق منها وتتناول الأحداث بشكل منطقي دون تزييف أو اختزال.
الرواية التاريخية تتقاطع مع الأيديولوجيا في كثير من الأحيان، حيث تُستخدم لتوجيه النقد الاجتماعي والسياسي أو تعزيز أفكار معينة. في “العطر” لباتريك زوسكيند، على سبيل المثال، يتم تصوير باريس في القرن الثامن عشر بشكل يعكس التفاوت الاجتماعي والفقر المدقع، مما يعزز موضوعات الانفصال بين الفرد والمجتمع.
س: ما هي خصوصية الرواية التاريخية العربية؟ وهل يمكن الحديث هنا عن إشكالية تشويه التاريخ فيها؟
ج: الرواية التاريخية العربية تعد نوعًا أدبيًا يعيد تصوير الأحداث التاريخية مع دمج الخيال لتقديم سرد جذاب ومتعدد الأبعاد. تُعتبر أعمال جرجي زيدان نموذجًا بارزًا في هذا السياق، حيث كان يهدف إلى تقديم تاريخ العرب والإسلام بأسلوب روائي يمزج بين الواقع والخيال. على سبيل المثال، في رواياته مثل “فتاة غسان”، “أبو مسلم الخراساني”، و”صلاح الدين الأيوبي”، تناول زيدان حقبًا تاريخية متعددة مستخدمًا الخيال لتغطية الفجوات التاريخية أو لجعل السرد أكثر تشويقًا. هذا المنهج الذي اعتمده جعل رواياته ممتعة لكنها تعرضت أيضًا لانتقادات بسبب تحريف بعض الحقائق التاريخية أو تقديم رؤية مُبسطة لا تعكس الواقع بدقة.
إشكالية تشويه التاريخ في الرواية التاريخية العربية:
إشكالية تشويه التاريخ ليست مقتصرة على جرجي زيدان فقط، بل تواجدت في العديد من الروايات التاريخية العربية الأخرى، حيث يعمد الكتاب إلى استخدام الخيال بشكل مبالغ فيه لملء الثغرات التاريخية. هذا الأسلوب قد يؤدي إلى تحريف السياق التاريخي في بعض الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض الروايات التاريخية الأيديولوجيا كأداة لإعادة صياغة الأحداث التاريخية لخدمة أهداف سياسية أو اجتماعية معاصرة، مما يؤدي إلى تقديم التاريخ بشكل مشوه أو موجه.
كذلك، يسعى الكتاب في بعض الأحيان لتبسيط الأحداث التاريخية لجذب القراء، وهو ما يؤدي إلى تقديم روايات سطحية تفتقر إلى العمق المعرفي والتاريخي. على سبيل المثال، “صلاح الدين الأيوبي” لجرجي زيدان قد تعرضت لانتقادات بسبب تبسيطها للأحداث التاريخية وتقديم صورة مثالية عن شخصية صلاح الدين، مما قد يثير تساؤلات حول دقة تمثيلها التاريخي.
نماذج عربية أخرى:
رواية “صلاح الدين الأيوبي” لجرجي زيدان تسلط الضوء على الحقبة الصليبية وصراع المسلمين والمسيحيين، لكنها انتُقدت بسبب تقديم رؤية مثالية لصلاح الدين وتبسيط الأحداث المعقدة.
رواية “أرض السواد” لعبد الرحمن منيف تناقش تاريخ العراق في فترة الاحتلال العثماني، ورغم عمقها التاريخي، إلا أنها واجهت نقدًا بسبب استخدام الخيال في إعادة تشكيل بعض الأحداث التاريخية.
روايات نجيب الكيلاني: مثل “عمر يظهر في القدس”، التي تستلهم التاريخ الإسلامي لمواجهة قضايا معاصرة، لكن هذه الروايات تثير جدلًا حول التفسير الأيديولوجي للتاريخ ومدى تأثيره على تمثيله بدقة.
س: كيف ننظر إذاً إلى ما قدمته الأديان الابراهيمية الثلاثة من قصص تاريخية متشابهة مثل: قصة الخلق- طوفان نوح- عصا موسى وانشقاق البحر- التيه اليهودي-أهل الكهف- سليمان الحكيم. هل يمكن اعتبار هذه القصص حقائق تاريخية فعلاً؟ أم هي روايات تاريخية ،وما هو معيارك أو برهانك لذلك؟
ج: القصص المشتركة بين الأديان الإبراهيمية كاليهودية والمسيحية والإسلام تحمل تشابهات كبيرة، لكنها لا تُعتبر حقائق تاريخية قطعية دون أدلة علمية وأثرية دقيقة. من منظور علمي وتاريخي، يمكن تحليل هذه القصص من خلال معايير متعددة. أولاً، المعيار الأثري والتاريخي، حيث يلاحظ غياب الأدلة المادية المباشرة على العديد من هذه الروايات، لكن هذا الغياب لا يعني بالضرورة عدم صحتها، فقد تكون مستوحاة من أحداث تاريخية محلية أو رمزية. ثانيًا، المعيار الثقافي والتراثي، إذ تعكس هذه القصص قيماً أخلاقية وتجارب الشعوب القديمة، وتنقل تراثًا روحياً وثقافياً غنياً. ثالثًا، من المعيار العلمي، يصعب إثبات بعض القصص كما وردت، لكن يمكن النظر إليها كتفسيرات رمزية أو مستندة إلى وقائع حقيقية أُضيف إليها عناصر خيالية أو مجازية. رابعًا، من المنظور الديني، يرى المؤمنون هذه القصص كحقائق مطلقة بينما ينظر إليها الباحثون كنصوص تحتاج إلى دراسة وتحليل، مع تفاوت التفسيرات بين الحرفية والرمزية. الخلاصة أن هذه القصص ليست حقائق تاريخية مثبتة لكنها تحمل قيمة تراثية وروحية عميقة، مما يتطلب التعامل معها بعقلانية وانفتاح والتركيز على جوهرها الأخلاقي والإنساني بدلًا من الوقوف عند حدود التفسير الحرفي.
س: أوافقك الرأي، ويحضرني سؤال: ما هو الفرق الذي يمكن توثيقه بين القصص والروايات التاريخية، وبين القصص والروايات التاريخية الدينية؟ هل توجد علامات سيميائية مثلاً؟
ج: الرواية التاريخية والرواية الدينية تتمايز في بنيتها السيميائية ومؤشراتها البنيوية، مما يعكس اختلاف أهدافها ووظائفها. الرواية التاريخية تعتمد على الوثائق والأدلة المادية، وتستند إلى مصادر متعددة وموثقة، مع تركيزها على التسلسل الزمني الدقيق، ولغتها الواقعية والموضوعية التي تقبل النقد والتعديل. بالمقابل، تعتمد الروايات الدينية على الوحي والتقليد الشفهي، ومصدرها النصوص المقدسة التي تحمل رمزية وأبعادًا روحانية، ولغتها تتسم بالرمزية والمجازية، وتقوم على الإيمان والتسليم.
على المستوى البنيوي، تتميز الروايات الدينية بوجود معجزات وأحداث خارقة للطبيعة، وشخصيات ذات أبعاد رمزية، وهدف تربوي وأخلاقي واضح، مع لغة إنشائية عاطفية. في حين تتميز الروايات التاريخية بالاعتماد على الأدلة المادية، وشخصيات واقعية، وهدف توثيقي وتسجيلي، ولغة تقريرية موضوعية. منهجيًا، تخضع الروايات التاريخية للنقد العلمي، بينما تُفسر الروايات الدينية غالبًا عبر التأويل الروحي.
رغم هذه الفروق، تتقاطع الروايتان في نقلهما لتجارب إنسانية تحمل رسائل ضمنية عن القيم والأخلاق، واستخدامهما للرموز واللغة المؤثرة لتقديم مضامينهما. هذا التحليل يوضح التمايز بينهما، مع الإقرار بإمكانية التداخل في بعض الجوانب التي تمزج بين التاريخي والديني لإيصال رسائل عميقة.
س: إذا هي في بنيتها تشبه الحكايات الأسطورية!
ج: القصص الدينية والأساطير تشترك في بنية ووظائف متقاربة تعكس طبيعة الإنسان في البحث عن المعنى، لكنها تختلف في مرجعيتها ومصدرها. من حيث البنية، نجد عناصر مشتركة مثل وجود أبطال خارقين، أحداث معجزية، وصراع بين الخير والشر، إلى جانب الرموز والإيحاءات العميقة التي تهدف إلى تقديم رسائل تربوية وأخلاقية.
أما من حيث الوظائف، فكلاهما يسعى لتفسير الظواهر الكونية، وتقديم نماذج سلوكية، وبناء هوية جماعية، ونقل القيم الأخلاقية، بالإضافة إلى تعزيز فهم الإنسان لعلاقته بالقوى العليا.
مع ذلك، يكمن الاختلاف الجوهري في المرجعية. الأساطير تنبع من سياقات تاريخية وثقافية وتتنوع بين الثقافات مع طابع تعددي وثني، بينما تستند القصص الدينية إلى الإيمان، مما يمنحها طابعًا توحيديًا ومركزيًا في منظومة القيم. هذه الفروق تجعل كلاً منهما انعكاسًا لرؤية الإنسان لعالمه، مع توافق في الهدف النهائي المتعلق بتفسير الحياة وتعميق الفهم الروحي.
س: أنت تفترض هنا أن النقاش يدور حول القصص الدينية في الديانات السماوية الثلاث. لكن ماذا لو عدنا إلى الأديان القديمة؟ ألا يصبح النص القصصي الديني هو الأسطورة ذاتها! ان كانت الإجابة بنعم، فهذا يعني أن هناك تداخلاً عميقاً بين هذه الأشكال القصصية الدينية عبر الزمن والأسطورة، ما رأيك؟
ج: هذه نقطة عميقة للغاية. في الحقيقة، الأديان القديمة مثل: – الميثولوجيا المصرية – الأساطير السومرية – المعتقدات البابلية – الأساطير الإغريقية والرومانية كلها تشكل نسيجاً واحداً من الروايات التي تمتزج فيها: – الدين – الأسطورة – التاريخ – التفسير الكوني فالخط الفاصل بينها شديد الرقة، بل يكاد يكون وهمياً. كل هذه النصوص: تفسر نشأة الكون – تشرح العلاقة مع القوى العليا – تؤسس منظومة أخلاقية – تحمل رموزاً عميقة.
النص الديني/الأسطوري هو في جوهره محاولة إنسانية لفهم الوجود وتفسير الغموض الكوني. رائع أنك دفعتني للتفكير خارج الصندوق!
س: لنفكر اذا خارج الصندوق، هل يمكن للسبب السابق، تفسير ظهور وازدهار تيار الواقعية السحرية في الأدب؟ سؤالي مبني على فرضية حضور الشعور الديني/ الروحي لدى الإنسان..
ج: في سياق التحولات المعرفية المعاصرة، تبرز الواقعية السحرية كامتداد معقد للوعي الأسطوري والروحي، حيث تشكل استراتيجية نفسية وثقافية عميقة لمواجهة التفكك المعرفي في العصر الحديث. على المستوى النفسي، تمثل محاولة جذرية لتجاوز المادية الضيقة، فهي تؤكد وجود أبعاد متخيلة تتجاوز المنطق الوضعي. إنها استجابة عميقة للحاجة الإنسانية في الهروب من التفسيرات العقلانية المحدودة، معيدة اكتشاف “السحر” المفقود في تجربة الوجود. ثقافياً، تعمل على استحضار الموروث الأسطوري والديني، مانحة المتخيل قدسية مماثلة للنصوص المقدسة. فهي تحافظ على “سحر” التفسير الكوني، وتعيد إنتاج الأسطورة بأدوات فنية معاصرة. في أعمال كتّاب مثل ماركيز في “مئة عام من العزلة”، وكافكا، وهاروكي موراكامي، تتجسد هذه “اللغة الروحية” كاستراتيجية معرفية تتجاوز حدود الواقع التقليدي. فهي ليست مجرد تقنية أدبية، بل منظومة معرفية معقدة تعكس الصراع بين الروحانية والمادية، محاولة جذرية لاستعادة “القداسة” في عالم علماني. وهكذا تظهر الواقعية السحرية كـ “لغة روحية” معاصرة، تعيد اختراع الأسطورة وتمنحها أبعاداً جديدة في سياق ثقافي متغير.
س: لماذا إذاً يميل الإنسان القارئ للأدب إلى تصديق هذا النوع من الروايات، وينظر إليها كمصدر للحقائق؟ ما هو السحر الذي يمتلكه النص الأدبي ليصبح ذا سلطة تتحدى الزمن؟ كيف مثلا يقتنع كثير من القراء بوجود قرية “ماكوندو” في “مئة عام من العزلة” لغابرييل غارسيا ماركيز؟
ج: الواقعية السحرية في “مئة عام من العزلة” لجابرييل غارسيا ماركيز تعتمد على آليات تصديق فريدة تجمع بين السرد الواقعي والعناصر الخارقة للطبيعة، مما يخلق عالماً داخلياً متماسكاً ومنطقاً خاصاً. التقنيات السردية تُبرز هذا التماسك من خلال تقديم تفاصيل دقيقة وسرد موضوعي حتى للأحداث الأكثر غرابة، حيث تبدو الخوارق جزءاً طبيعياً من حياة الشخصيات.
تُعزز هذه الآليات النفسية من خلال محاكاة آليات الذاكرة الجماعية واستحضار التجارب الشعبية والتراث الشفهي، ما يجعل الخارق مألوفاً ومقبولاً ضمن سياق الحياة اليومية. على الصعيد الأنثروبولوجي، توظف الرواية الأساطير والتاريخ المحلي لخلق عالم موازٍ يقنع القارئ بوجوده. ماكوندو ليست مجرد قرية، بل تمثل كوناً متكاملاً يجمع بين الأسطورة والواقع، مما يجعل التصديق جزءاً من تجربة القراءة نفسها.
س: ما تبرير تلك اللعبة إذا التي يحب بعض الكتاب استخدامها، فهم يؤكدون على أن كتابهم لا يمت للواقع بصلة؟ أقصد، هناك دائماً نية مضمرة ومسبقة لدى القارئ بالتصديق، فلماذا يتلاعبون بذلك؟ هل القصد هو إثارة الفضول؟
ج: الدافع وراء الواقعية السحرية أعمق من إثارة الفضول، إذ يرتبط بأبعاد معرفية، سياسية، وجودية، ونفسية تعيد تشكيل الواقع وتحرره من قيوده. معرفياً، تكشف الواقعية السحرية محدودية المنطق الوضعي، وتفكك الثوابت التقليدية، وتبتكر رؤى جديدة للواقع. سياسياً، تُستخدم كأداة مقاومة ثقافية ترفض السرديات الرسمية وتستعيد أصوات المهمشين. وجودياً، تتيح استكشاف أبعاد متخيلة تتجاوز التفسيرات المباشرة، وتخلق مساحات غنية للتأويل. نفسياً، تحاول إعادة سحر العالم المفقود بإحياء البعد الروحاني وكسر رتابة الواقع المادي. الهدف الأعمق هو إعادة اختراع الواقع ليصبح فضاءً مفتوحاً للإبداع والتحرر من القيود المعرفية الضيقة.
س: إذاً يميل المؤلفون إلى إنشاء افتراضي ذهني لمتلق يستطيع الاقتناع بنصوصهم، إذا هناك مشكلة لدى من يملكون عقلا نقدياً في قبول النص الأدبي كمصدر للحقائق. هل هناك اذا على ما يبدو انتشار واسع لذلك القارئ المفترض الذي يحب الاستمتاع بالقراءة دون طموحات معرفية أخرى؟
ج: سؤال نقدي يلمس جوهر الإشكالية الثقافية المعاصرة! هذا “القارئ المفترض” يمثل حالة ثقافية معقدة تنبع من منظومة متشابكة من العوامل: على المستوى النفسي، يبحث هذا القارئ عن الهروب من الواقع، ويرغب بتجربة وجدانية عاطفية تمنحه متعة الاستهلاك الثقافي السريع. فهو يميل للاستمتاع دون نقد معمق، مفتقراً للأدوات النقدية المتقدمة، ويقبل السرد كـ “حقيقة” عاطفية. على المستوى الاجتماعي، يظهر كنتاج لمنظومة تعليمية تكريسية تعاني من ضعف التربية النقدية. فالثقافة تستهلك كـ “منتج ترفيهي” يميل إلى التسطيح، حيث تطغى ثقافة الترفيه على المعرفة، وتتراجع القراءة النقدية العميقة. اقتصادياً، تدعم صناعة النشر هذا التوجه من خلال إنتاج أدب تجاري يستهدف الجماهيرية، يميل إلى تبسيط المحتوى لزيادة المبيعات. فالناشرون يستثمرون في المحتوى السهل الممتنع الذي يلبي رغبة القارئ في الهروب والمتعة. النتيجة هي نموذج قارئ “متوسط” يمثل الحالة السائدة: يستهلك الثقافة كترفيه، يبحث عن المتعة وليس المعرفة، ويفتقر للدافع المعرفي العميق. إنه يعكس أزمة ثقافية في إنتاج وتلقي المعرفة، حيث يصبح الأدب مجرد وسيلة للهروب بدلاً من أن يكون أداة للنقد والاستكشاف.
مجلة قلم رصاص الثقافية
 مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.
مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.