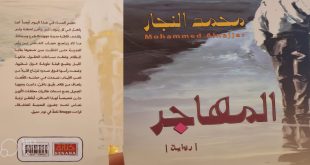رغم أفول نجم الأيديولوجيات التقليدية التي سادت وتسيدت العالم في القرنين الماضيين، وانتهت إلى ما انتهت إليه اليوم، لا يزال كثر يصرون على استخدام الأيديولوجيا كسلاح تعبئة وتحشيد للجماهير، ومما يعزز فاعليتها ويعمق أثرها في مجتمع ما؛ الاستبداد والجهل بالدرجة الأولى، وبالتالي ستفقد تلك الفاعلية إن جوبهت بالتحرر الفردي والوعي والتنوير الممنوع، ورغم أن غالبية أنصارها ينظرون إليها بينهم وبين أنفسهم كتحصينات دفاعية للسلطة ضد الداخل، إلا أنها لن تكون كذلك إن لم تكن مقرونة بالعمل والإنجاز وتحسين الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشرائح المستهدفة في المجتمع الذي تستخدم فيه، فشعوب اليوم غير شعوب الأمس، وأما من ينساق خلفها دون تحقق ذلك الشرط فهم الغوغاء والسوقة والرعاع والوصوليين والانتهازيين ومن لف لفهم ممن يحبون القعي وبسط الأكف عند أعتاب السلطة.
كما يرى آخرون من أنصارها أنها تحصين للداخل ضد الخارج، وهذه لا طائل منها أيضاً بعد الذي شهده العالم من تطورات وتغيرات سريعة جعلت الخارج المقصود بالسردية قادراً على اختراق ودك أقوى التحصينات وتحويلها إلى هباء منثور في طرفة عين، فثقب صغير في جسم سد ضخم سيكون كفيلاً بانهياره في لحظة ما، لذا؛ الرهان على الأيديولوجيات العبثية والإصرار على إعادة بثها اليوم وسط حالة الفوضى والتيه وعدم الاستقرار هو رهان خاسر بالضرورة، ومن لم يستفد من تجارب الأمس لتلافي الأخطاء سيظل حبيس ماضيه وسيعود للوراء، وهنا ستصير المراوحة في المكان إنجازاً تاريخياً.
في الحالة السورية على سبيل المثال لا الحصر، التقط “منظرو” حزب البعث الحاكم الجدد أنفاسهم، وحشدوا طاقاتهم منذ ربيع عام 2011 ليستعيدوا دوراً فقدوا بعضه مع إزاحة الحرس القديم من المشهد واتجاه البلاد إلى شيء من الانفتاح، وهم يدركون أنهم يحاولون بث الروح في جثة هامدة لكن لا ضير ما دام أن هناك من يلغي عقله، فكانت محاولات الإنعاش الخطابية التي قاموا بها تزلفاً للسلطة كارثية بنتائجها، فقد دفعت بعشرات آلاف القرابين على مذبح السلطة، هؤلاء مثلاً لم يزجوا بأولادهم في معارك “الدفاع عن الوطن” التي دفعوا بأولاد الآخرين إليها، وإنما احتفظوا بهم لأنفسهم، بل وأكثر من ذلك؛ لقد عاشوا طيلة سنوات الصراع بمستوى من الرفاهية، ربما لم يكونوا لينعموا به في زمن الاستقرار، بينما عانى غيرهم من كل أنواع الخوف والحرمان والضياع والقهر والذل بمستويات مختلفة.
لطالما راهن هؤلاء على فاعلية الأدلجة أمام السلطة ودورها في حمايتها، كيف لا وهم “أزلامها” وتلك أقدس مهامهم، لكنهم حين يخلون لأنفسهم يراهن أغلبهم على المال فقط، فهم يدركون أنَّ السلطة قد تزول، لكن للمال سلطة لا تزول، سلطة صالحة لكل زمان ومكان، فهم يعرفون جيداً أن المال هو وحده القادر على جعلهم في مأمن بظل أية سلطة، وقد كسبوا الرهان وربحت تجارتهم.
ما دام لكل سلطة أزلامها ومستزلميها، والجهل يحكم واقعنا والغرائز تغلب العقول، سنظل أسرى للأيديولوجيين السلطويين على المستويين الفردي والجمعي وبالتالي لا يمكن أن نكون جموعاً متحررة، لأن تحطيم الأصفاد إن لم يبدأ من الفرد بذاته لن يؤدي في النهاية إلى شيء، بل قد يؤدي في بعض الظروف إلى حالة نكوص تدفع حتى من حطم أصفاده للبحث عن أخرى يقيد نفسه بها تأثراً بعدوى القطيع.
إن أدلجة الأطفال على نحو خاص، والشباب بطبيعة الحال، تحولهم إلى ما يشبه البيادق على رقعة الشطرنج، وهي بذلك تؤهلهم ليموتوا دفاعاً عن الملك في معركة مهما تأخرت هي قادمة، وبالتالي يعكس الإصرار عليها رغم أننا في نعيش اليوم في زمن التحولات السريعة ومن المفترض أن نجاريه، إلا أنَّ البعض ونكاية بأيديولوجيا مهترئة يصرون على اجترار أيديولوجيا أخرى بالية، ويعيدون الزمن إلى الوراء، ويحاولون أن يجعلوا منها هوية جمعية تُحشد خلف السلطة الحشود للدفاع عنها. وبينما يتلذذ المؤدلجون بنعمها (السلطة) يُلقى بالمؤدلجين في معركة الدفاع عنها ليكونوا أول الضحايا.
لذا؛ قُد معركتك، معركة التحرر الفردي والوعي ضد الجهل، ولا تكن بيدقا في معركة أحد، أيا يكن هذا الأحد، وحاول ألا تقع في الأسر، أسر “منظرو” الأيديولوجيات الذين لا تهمهم سوى مصالحهم المرتبطة ببقاء السلطة، لأنك متى وقعت في الأسر صار بالإمكان تحويلك في أية لحظة إلى بيدق في معارك الآخرين، وزجك في أتون معركة أوهمت فتوهمت أو أُقنعت أنها معركتك وغايتها سامية نبيلة رغم ألا ناقة لك فيها ولا جمل، لذا؛ لا تتسابق على الموت بدفع ممن يسابقوك على الحياة، لتعلم أن حياتك ثمينة وإن خسرتها ستكون الخاسر الوحيد مهما كانت نتيجة المعركة الفاصلة التي خيضت بك وبأمثالك من المخدوعين.
إنَّ أعلى درجات الغباء هي قيامك بما يُراد منك أن تقوم به، بينما تعتقد أن هذا ما تريده أنت، دون أن تدرك أنك مجرد بيدق وقعت ضحية للأدلجتين الصلبة والناعمة.
مجلة قلم رصاص الثقافية
 مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.
مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.